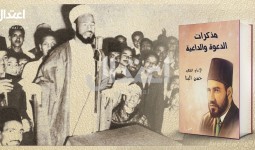يطالعنا الإمام الشهيد حسن البنا (1906 – 1949م) -في مطلع العصر الحديث- بمنهج فكري وسطي تقريبي، يطرح قضية "الوحدة الإسلامية" عاملاً أساسيًا لعلاج مشكلات العالم الإسلامي –آنذاك– وعلى رأسها الاستعمار، وكذلك محورًا جوهريًا لعلاج مشكلة التراجع الحضاري بعد سقوط الخلافة الإسلامية.. لذلك جاءت رسائله وخطبه في تشخيص هذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية وبيان سببه الرئيسي المتمثل في الخلافات بين المسلمين والتي أودت بحاضرهم ومستقبلهم إلى ما هم عليه حتى الآن.
وانطلاقًا من هذه المسؤولية الحضارية التي تحملها الإمام الشهيد تجاه "الأمة الإسلامية" طرح برنامجًا ومنهاجًا التزمه هو أولًا، ثم مدرسة الاعتدال من بعده, تمثل في هذا النهج الوحدوي والتقريبي بين عناصر "الأمة"، وكان في ذلك أمينًا على أمته ودينه في مقابل عناصر التفريق والتباعد. ونطرح فيما يلي أهم معالم المنهج التسامحي الذي خطه الإمام حسن البنا لمدرسة الاعتدال الإسلامي:
أولًا: مشروعية الاختلاف لا مشروعية النزاع والعداء:
أكد الإمام الشهيد في منهجه الفكري على مشروعية الاختلاف الفكري والفقهي، إلا أنه نهى عن أن يكون هذا الاختلاف سببًا للنزاع والعداء بين المسلمين، وقد وضع لهذه الفكرة ثلاث قواعد جوهرية هي:
القاعدة الأولى: الوحدة لا الفرقة
يقول الإمام الشهيد "فاعلم – فقهك الله – أولاً أن دعوة الإخوان المسلمين دعوة عامة لا تنتسب إلى طائفة خاصة، ولا تنحاز إلى رأي عُرف عند الناس بلون خاص ومستلزمات وتوابع خاصة، وهي تتوجه إلى صميم الدين ولبه، ونود أن تتوحد وجهة الأنظار والهمم حتى يكون العمل أجدى والإنتاج أعظم وأكبر.. فدعوة الإخوان دعوة بيضاء نقية غير ملونة بلون، وهي مع الحق أينما كان، تحب الإجماع وتكره الشذوذ، وإن أعظم ما مني به المسلمون الفرقة والخلاف، وأساس ما انتصروا به الحب والوحدة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هذه قاعدة أساسية وهدف معلوم لكل أخ مسلم، وعقيدة راسخة في نفوسنا، نصدر عنها وندعو إليها"(1).
هذا النص يبين بوضوح خاصية "الإسلامية" التي وصف بها الإمام الشهيد دعوته – في هذه الرسالة – وما تتميز به من اتساع وشمول بحيث أضحي منهج هذه الدعوة غير مقيد بزي خاص ولا عصبية مقيتة ولا مذهبية عمياء، وهذا هو الإسلام نفسه الذي أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم (رحمة للعالمين)، (لتعارفوا) (إن أكرمكم عند الله اتقاكم)، وبهذا النهج الفريد لدعوة الإمام الشهيد تتربى طائفة كبيرة من الأمة الإسلامية استنادًا إلى هذا المنهج القويم الذي يدعو المسلمين إلى "الحب" و"الوحدة" ونبد "الخلاف" و"الفرقة" (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم) [آل عمران:103] فالإسلام جاء لتأليف القلوب لا لغرس البغضاء باسم الإسلام.
القاعدة الثانية: ضرورة الخلاف
كان الإمام الشهيد – رحمه الله – مربيًا دارسًا لكتاب الله وطبائع النفس لبشرية ومقاصد الخلق، لذلك فإن الوحدة الفكرية التي نشدها الإمام لا تعني بالضرورة صب المسلمين في قوالب فكرية واحدة جامدة لأن ذلك يخالف الشرع الذي أكد على اختلاف الناس، وهنا يذكر الإمام قوله: "ونحن مع هذا نعتقد أن الخلاف في فروع الدين أمر لابد منه ضرورة، ولا يمكن أن نتحد في هذه الفروع والآراء والمذاهب لأسباب عدة منها:
- اختلاف العقول في قوة الاستنباط أو ضعفه وإدراك الدلائل والجهل بها والغوص على أعماق المعاني.
- ارتباط الحقائق بعضها ببعض، والدين آيات وأحاديث ونصوص يفسرها العقل والرأي في حدود اللغة وقوانينها، والناس في ذلك جد متفاوتين فلابد من خلاف.
- سعة العلم وضيقة.. وإن هذا بلغه ما لم يبلغ ذاك والآخر شأنه كذلك.
- اختلاف البيئات حتى إن التطبيق ليختلف باختلاف كل بيئة.
- اختلاف الاطمئنان القلبي إلى الرواية عند التلقين لها.
- اختلاف تقدير الدلالات فهذا يعتبر عمل الناس مقدمًا على خبر الآحاد مثلاً وذاك لا يقول معه به وهكذا (2).
القاعدة الثالثة: صعوبة الإجماع على أمر فرعي
يقرر الإمام الشهيد في هذه القاعدة – وبعد هذه المقدمات المنطقية في المحورين السابقين – أن "الإجماع على أمر واحد في فروع الدين مطلب مستحيل، بل هو يتنافى مع طبيعة الدين، وإنما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد عبر العصور ويماشي الأزمان، وهو لهذا سهل مرن هين لين لا جمود فيه ولا تشديد"(3).
ويؤكد – هنا – على خاصية التعددية الفكرية التي تستند في جوهرها إلى النص القرآني، الذي يبرز لها أصولًا متعددة في وجه القائلين بالأحادية الفكرية التي نهى عنها الكتاب الكريم ونفاها باعتبارها – أي الواحدية – تخص الله وحده، ولا تخص أيا من مخلوقاته، والإمام بذلك يساهم في إرساء أصول إسلامية للتعددية الفكرية في المجتمع الإسلامي، التي هي الوجه الحقيقي للوحدة الإسلامية، ومنهج الشهيد في ذلك يعتمد في جوهره على الأصول القرآنية التالية التي تؤهل لمفهوم التعددية بوجه عام، ومن هذه الأصول: أصل التنوع، والاختلاف، والحرية. وقد بلغ تعداد المذاهب الفقهية التي نشأت في ضوء هذه الأصول ما يزيد على عشرة مذاهب – هو ما وصلنا أو ما عرفناه - ظل يُعمل بالكثير منها حتى اليوم، ومنها:
1- مذهب أبي حنيفة النعمان (80 هـ - ت 150 هـ).
2- مذهب مالك بن أنس (93 هـ - ت 179هـ).
3- مذهب محمد بن إدريس الشافعي (150 هـ - ت 204 هـ).
4- مذهب أحمد بن حنبل (164هـ - ت 241هـ).
5- المذهب الزيدي (زيد بن علي) (80 هـ - ت 122هـ).
6- المذهب الجعفري (جعفر الصادق) (80هـ-ت148هـ).
7- مذهب الأوزاعي (88هـ - ت 157هـ).
8- مذهب سفيان الثوري (97 هـ - ت161هـ)
9- مذهب داود الظاهري (200 هـ - ت270هـ).
10- مذهب ابن جرير الطبري (ت310هـ).
وهناك مذاهب أخرى لم نعرفها ولم ينشرها أصحابها ولا تلامذتهم، ولم يجدوا من الحكام من يتبنى مذهبهم فيعمل على نشره وإذاعته بين الناس. وقد تراوحت الاختلافات الفقهية في نوعية وترتيب الأدلة الشرعية وإن كانت كل المذاهب تتفق على أسبقية الكتاب والسنة وصدارتهما لكل الأدلة، إلا أن الاختلاف كان في الآليات التي يمكن أن نستنبط منها الحكم هل بظاهر النص؟ أم بتأويله؟ هذا فيما يتعلق بالوحي، أما الأدلة الأخرى فتراوحت بين العمل بالرأي كما عند أبي حنيفة، إلى الإجماع عند مالك، والقياس عند الشافعي، وفتوى الصحابي عند أحمد بن حنبل(4).
- الإجماع: ويعني: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة ما.
- القياس: وهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.
- الاستحسان: هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة لدليل يقتضي هذا العدول.
- المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يشرع الشارع أحكامًا لتحقيقها، ولم يقم دليل معين على اعتبارها أو إلغائها.
- سد الذرائع "الوسائل": ويعني سد الوسائل والأفعال والطرق المؤدية إلى الشر والفساد أو فتح الوسائل والأفعال والطرق المؤدية إلى المصالح والإصلاح.
- العرف: هو ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قول أو فعل أو ترك بما لا يخالف الشرع، أما العرف الفاسد فلا خلاف بين الفقهاء على تركه وعدم اعتباره.
- مذهب الصحابي: ذهب بعض الفقهاء إلى أن قول الصحابي حجة يجب اتباعها، وللمجتهد أن يتخير من أقوال الصحابة ما يراه أقرب إلى الكتاب والسنة.
- شرع من قبلنا: وهي الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم.
- الاستصحاب: ويعني الحكم ببقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييره.. أو هو بقاء الحكم الثابت في الماضي حتى يقوم الدليل على تغيره.
ويحصي الطوفي (ت 716 هـ) تسعة عشرة دليلاً عند الفرق الإسلامية جميعًا "أولها الكتاب، وثانيها السنة، وثالثها إجماع الأمة، ورابعها إجماع أهل المدينة، وخامسها القياس، وسادسها قول الصحابي، وسابعها المصلحة المرسلة، وثامنها الاستصحاب، وتاسعها البراءة الأصلية، وعاشرها العادات، الحادي عشر الاستقراء، الثاني عشر سد الذرائع، الثالث عشر الاستدلال، الرابع عشر الاستحسان، الخامس عشر الأخذ بالأخف، السادس عشر العصمة، السابع عشر إجماع أهل الكوفة, الثامن عشر إجماع العترة عند الشيعة, التاسع عشر إجماع الخلفاء الأربعة"(6).
إن اختلاف الفقهاء كان علامة مضيئة في تاريخنا الإسلامي وهو نتاج واضح لأصل "التعددية" و"الحرية" و"التنوع" الذي أقره الإسلام متمثلاً في الوحي، وقد صدقه الواقع في أقرب شيء إلى الإسلام وهو "التشريع"، هذا لا ينفي بالطبع "الصدمات" و"الصدامات" المقلقة التي نشأت على هامش هذه الحرية الفكرية التي عاشها العقل حوالي ما يقرب من أربعة قرون.